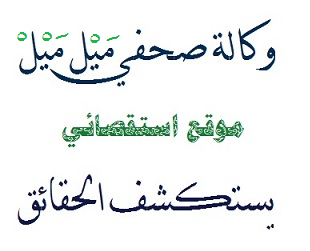الإعلام الرسمي فى خدمة الجهاز التنفيذي
افتتحت الحكومة الموريتانية مكاتب للإذاعة و للتلفزيون الرسميين فى كافة النقاط المتاحة و خاصة عواصم الولايات .
و قد انحصر الجديد في هذا الاجراء فى تطويل النشرات و التغطيات و التحقيقات لكن فى دائرة المعتاد : أن ينحصر دور الإعلام الرسمي فى مواكبة السلطة التنفيذية حتى داخل المراحيض لتظهر قطع الذهب التي تركمها داخل هذه المراحيض ، فكل أفراد الأجهزة التنفيذية يتغوطون ذهبا و يتبولون عسلا و يتمخضون زيت زيتون و لا يخرجون إلا طاهرا منتفعا به معلوم القدر معلوم الوجود مقدورا على تسليمه و تسلمه كما يشترط فى الثمن والمثمون فى أي عقد بيع او في مهر مؤمنة قانتة …
فعلا تم استيعاب كل المتطفلين على حقل الإعلام و كل الهواة و كل الذين كونهم الموهوب الاستاذ محمد ولد محمدلمين في منزل كرفور لكبيد …
تم امتصاص بطالة لو تركت لقدرها لكانت وضعت كل شيء على اثير الواقع و سيصبح كل شيء مكشوفا .
لكن اركان الظلام و صراصير الفساد تسابقوا فى اقناع الجهات المعنية باكتتاب هذا الجيش من الاضواء الكاشفة خوفا من قدرته الفائقة على كشف عورات وزراء يمتنعون من اكتتاب الاطباء و المدرسين و من على شاكلتهم من مستخدمى الاجهزة الخدمية و يفضلون ابتكار خدعة مقدمى الخدمات المخالفة للقوانين و النظم المعمول بها فى الجمهورية الاسلامية الموريتانية .
لقد نجحت استشارة المكلف بمهمة فى وزارة الداخلية فى الاستثمار فى وسائل الاعلام للسيطرة عليه و اسكاته و بالمقابل مناهضة الاعلام الحر و تمييعه …
من الواضح الجلي أن وسيلة إعلام تمتلك كافة المعدات و التجهيزات و تمتلك القدرة الكاملة على الوصول لمصادر الاخبار … لا يمكن مقارنتها بوسيلة إعلام حرة أغلب أفرادها مندسون أو عملاء و محظور وصولها الى اي نشاط ..
و رغم ذلك فشلت وسائل الإعلام الرسمية فى كسب ثقة الشعب فى الوقت الذي نجحت وسائل إعلام حرة لمصداقيتها و صدقيتها .
إن الاستمرار فى ارتهان الإعلام الرسمي للاجهزة التنفيذية -و هو وحده القادر ماديا و معنويا على الولوج لمصادر الاخبار-نتج عنه تغول تلك الاجهزة و بعدها عن مهامها الاصل لأنها بكل بساطة تملكت الوسيلة التى كان من المفترض ان تخاف رقابتها …
فكيف نبرر تحصين اى فرد من الاجهزة التنفيذية و منع الاعلام من مراقبة عمله لنمكنه بذلك من ارتكاب أخطاء لن تقتصر على فشل المهمة الموكلة اليه فقط و لكن قد تنقلب أخطاؤه الى سيف مسلول على رقبة الكيان الموريتاني بكامله ؟.
إن أكبر القضايا التي تشغل دولتنا منذ أحداث اضراب عمال ازويرات في الستينات و حتى حرق عريش الشرطة فى معبر كوكى قبل يومين لو تمكن الإعلام المهني من تقديمات تحقيقات استقصائية حولها لمكنت من إعادة هذه القضايا الى مكانتها الطبيعية لينكشف بالتالي صيادو المياه العكرة و تنقطع الحبال فى صيادى الشرور و الفتن .
لو ان تحقيقات صحفية مهنية طالت الانقلابات فى البلاد و بينت حقائق ما جرى من اغتيالات و دعاوى إبادة لانقلب ما سمي بملف الزنوج الى قضايا قضائية فردية محضة تولدت عنها قضايا فرعية أخطر منها تمثلت في وجود عصابة تعمل على ارتهان وطن بكامله للتغطية علي أفراد لا يستحقون سوى تقديمهم لحبال المشانق ليس إلا .
و لو أن تحقيقا صحفيا مهنيا مكن صاحبه من متابعة دعاوى و شكاوي المسفرين من سرقة مقتنياتهم مما تسبب فى قضية كوكى سالفة الذكر .
يمكن ان نقول بكل اطمئنان أن مناط انتشالنا من الاوضاع الراهنة يشترط فيه الطلاق البات بين الإعلام الرسمي و بين الاجهزة التنفيذية ثم تمكين هذا الاعلام من ان يكون بالفعل سلطة رابعة قادرة على رد الامور الى نصابها و تصحيح المختل من الاوضاع …
لن ينقذ الوضع الحالي للبلد غير السلطة الرابعة فصاحبة الجلالة هي وحدها القادرة على مجابهة الفساد المنتشر و ليس بمقدور أية سلطة أخري أن تحل محلها .
إن التحقيقات الصحفية المهنية هى وحدها القادرة على تحديد نقاط الخلل و مناطق الوجع فى جسم يريد له المفسدون ان يتحلل ليذيب الاحماض القادرة على تحديد الاسباب الحقيقية لذلك كله .
و لن يكون الصحفي مهنيا إلا إذا كشف الحقائق بالادلة و البراهين بعيدا عن صحافة رجع الصدى التي تعتمد على معلومات يقدمها طرف فاسد ضد طرف ثان فاسد هو كذلك لا يقبل اي منهما ان يتجاوز منطقة الشخصي مع الحفاظ التام على سرية منطقة المشترك بينهما و هو سر الفساد الحقيقي الذى ما زال حتى الان عصيا على التحديد …
فهل ينجح الجهاز التنفيذي فى دوام لجم حرية الصحافة حتى يتمكن من التضحية برأس النظام و يستبدله برأس جديدة أم أن رأس النظام سيقتنع بأن عليه أن يتغدي بالمفسدين قبل أن يتعشوا به !!؟؟.
الاكيد أن أحد الطرفين سيتم الفتك به لأن البلاد السائبة جربت كيف تتغلب على ما يبيت لها من مخططات مهما كان خبثها خاصة فى هذه الايام التى أظهرت تداعى أبنائها الحقيقيين الى قصعة التواصي بالحق و التواصي بالصبر ..
محمدالمهدي صاليحي